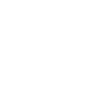«لأَنَّكَ رَأَيْتَنِي آمَنْت؟ طُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَوا وآمَنُوا!»
07Apr
ألقيامة حدث تاريخي لا مثيل له في التاريخ.
لم يُسجّل التاريخ أن أحداً خرج من الحياة ثم عاد إليها.
فالموت هو موت للحياة وليس مزحة، فمن مات في لحظة لن يرى ما قبلها أبداً ولن يراه أحداً كما كان قبلها.
هذه حقيقة يعرفها كل إنسان ناضج وغير ذلك لم يحصل سوى مع يسوع فجر أحد القيامة، الذي خرج من القبر سالماً وظل أربعين يوماً يظهر لتلاميذه، أراهم علامات موته من جروح الطعنات وآثار المسامير، حضّر لهم الفطور على شاطئ بحيرة طبرية وأكل معهم ورافقهم إلى صيد السمك طالباً منهم أن يلقوا الشباك في العمق فملأوا مركبتين من وفرة ما اصطادوا.
لكن توما لم يكن بينهم ولم يقتنع لا برواية النساء ولا برواية التلاميذ.
وفي هذا الموقف شجاعة تميز بها توما عن سائر رفاقه، هو الذي طلب منهم مرافقة يسوع إلى بيت عنيا حيث حصلت أعجوبة لعازر، وكان توما يعلم أن هذا الأمر سيقوده إلى الموت فبيت عنيا قريبة من أورشليم وهناك ينتظره اليهود بفارغ الصبر بغية التخلص منه «فَقَالَ تُومَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ لِلتّلاَمِيذِ رُفَقَائِهِ:
«لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نَمُوتَ مَعَهُ». (يوحنا ١١: ١٦).
وعندما أخبر يسوع تلاميذه أنه سيتركهم ويذهب لإعداد مكان أفضل لهم،«وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ الطَّرِيقَ»، كان لدى توما كل الشجاعة ليسأله: «يَا سَيِّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ الطَّرِيقَ؟»كل التلاميذ سمعوا ولكنهم لم يفهموا قصد يسوع، وحده توما سأل طلباً للمعرفة والفهم وليس من باب التشكيك أو الإستخفاف والدليل أن يسوع أجابه بكل وضوح وجدّية :
«أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى الآبِ إِلاَّ بِي. لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضا. وَمِنَ الآنَ تَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ».
(يوحنا ١٤: ٤-٧).
ربّما كان توما أكثر واقعية من باقي التلاميذ وربّما كان خائفاً أكثر منهم وربّما عبّر عن خوفه بالاستقلال عن التلاميذ والإختلاء بنفسه لئلا يصيبهم أكثر بالإحباط وفقدان العزيمة على إكمال حياتهم.
«أَمَّا تُومَا أَحَدُ الاِثْنَيْ عَشَرَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعُ».
(يوحنا ٢٠: ٢٤)
ترك توما التلاميذ لأكثر من سبب، خرج من شركة الجماعة الأولى وابتعد فإزدادت حياته تعقيداً وبقي أسبوعاً كاملاً يتخبّط مع نفسه غير مقتنع برواية النساء اللواتي إكتشفن قبل الجميع أن القبر فارغ وأن يسوع قام من الموت وسبق التلاميذ إلى الجليل.
من المهم الحفاظ على الحضور داخل الجماعة وقت المحن، من هنا نفهم لماذا يلجأ المؤمنون إلى الكنائس حين يداهمهم الخطر.
كان توما شجاعاً حين كان بالقرب من يسوع وفقد تلك الشجاعة حين ابتعد عنه يسوع وابتعد هو عن التلاميذ.
لمدة ثمانية أيام (تمثل حياة الانسان) أغلق على نفسه كل نافذة يمكن أن يتسلل منها نور القيامة لأنها حديثة جداً لا مثيل لها تشبه إلى حدٍ ما الخوارق التي اخترعها الانسان، فكانت فوق إدراكه ويستحيل عليه أن يقبلها دون قناعة.
عند كل اختراع جديد يتردد الناس في قبوله وينقسمون بين محافظ على ما اعتاد عليه وبين من يركب طور الحداثة بسرعة.
لكن فيما بعد يحتكمون في شأنه إلى أمرين: أولاً مدى قبول العقل له وثانياً مدى المنفعة منه.
أما في موضوع القيامة فهي فائقة الطبيعة وأسمى من أي اختراع ولا يمكن الاحتكام إلى العقل في فهمها، أما في أمر المنفعة فالقيامة ستحمّل من يقبلها ويؤمن بها رسالة من نوع آخر تقوده إلى الحب الأعظم وبذل الذات في سبيل الأحبّاء.
ربّما نتهم توما بالشكّاك عن غير حق وأنه لم يؤمن بقيامة يسوع إلا حين وضع إصبعه في جنبه المطعون وأيضًا عن غير حق.
آمن توما حين رأى ولم يضع إصبعه في الجرح، فالإيمان لا يرتكز إطلاقاً على منطق العقل بل على منطق الحب، ساعتئذٍ سجد فتحوّل من حالة التردد إلى حالة العبادة "أَجَابَ تُومَا وقَالَ لَهُ:
«رَبِّي وإِلهِي!»".
إنطلق توما مع الرسل حاملين بشرى القيامة إلى كل العالم بإمكانيات جداً محدودة مزوّدين بطاقة لا حدّ لها وبمواهب الروح القدس فأحدثوا أكبر ثورة حبّ في التاريخ غيّرت وجه الأرض إلى غير رجعة.
رأى توما وآمن "فطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَوا وآمَنُوا!".
أي الطوبى لكل الاجيال التي عشقت وجه المسيح دون أن تراه، والطوبى لكل من يعيش مفاعيل القيامة في حياته في كل زمان ومكان وفي كل الأحوال.
إبن القيامة لن يُغلق على نفسه الأبواب مهما اشتدّ عليه الظلام خارجاً، وإبن القيامة لا يسكن القبور لأنه ذهب مع حاملات الطيب فجر الأحد واكتشف أن القبر فارغاً لا أحد يسكنه، وإبن القيامة يقطع الشرّ مهما كان جامداً ويحوّل نشاذه إلى نغمات تطرب النفوس وتشعل القلوب بنار الحبّ.
وحين يداهمه الشكّ يُسرع إلى أقدام المعلّم ويسجد أمامه مرنّماً مع توما أنشودة القيامة : "رَبِّي وإِلهِي".
أحد مبارك
/الخوري كامل كامل/
تعليقات